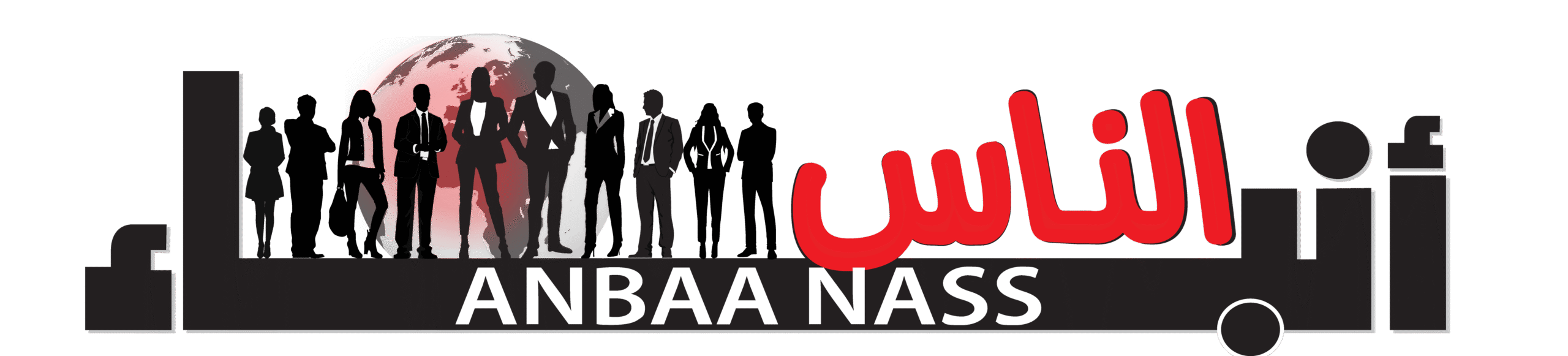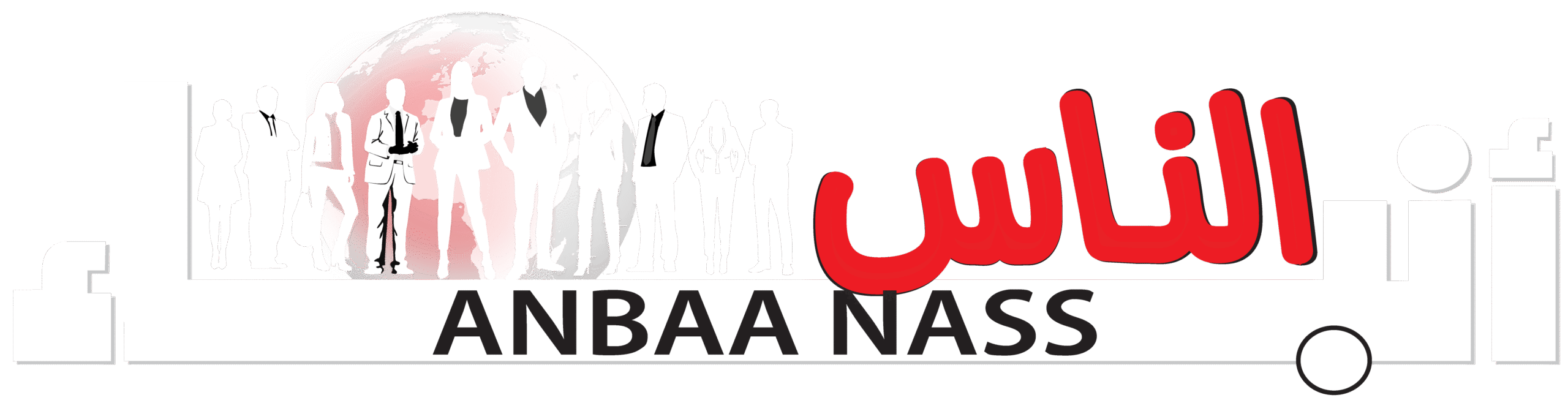لم يكن له في الحَرْف أو الفكر ولا السياسة ،بل له فهم في علم إجتماع الناس، ولم يكن له وعي في الفلسفة ولا في سؤالها الذي هو سبب وجودها “لماذا”، ولكن دائما كان يسأل لماذا “رَدُٓونِي”، ولكثرة سؤاله لماذا “ردوني” أجمع من عاشره من رفاقه وبني قبيلته على تسميته ب “رديدة” فأصبح يُعْرف به حتى نسى الكل إسمه إلا المقربين من بني عشيرته .
وأنا أستمع إلى عيطة الراضوني تذكرته حين كنت أعمل في نطاق الصحة القروية بمركز صحي بالشياضمة ، لم يكن طبيبا أو ممرضا أو تقني فقد كان يجاور المستوصف ويتعامل مع موضفيه ويقوم بواجبات غير رسمية في وجود فراغ في بعض المهام، وكان من الشغوفين بفن العيطة ودائما عندما يترك له الخيار يشيد بعيطة الراضوني ويترافع من أجلها كأحسن عيطة حصباوية ، ولكثرة إندهاشي من تعلقه بها ، سألته ذات مرة: ما الذي يشدك إليها ؟، فأجابني إنها تلازمني منذ أن وعيت وبدأت أبحت عن فرض وجودي من خلا العمل ،وكان حينئذ الفرنسيون يجمعون العمال المغاربة للبناء وجني العنب لبناء اقتصادهم بعد أن دمرته الحرب العالمية الثانية ، فرُفِضْتُ أو رُدِدْتُ لصغر قامتي وبدانتي فتقدمت إلى الجيش المغربي تلبية للواجب الوطني وهو في طور البناء والتشييد ، فرُدِدْتُ لنفس السبب، فقصدت مدينة الدار البيضاء للبحت عن عمل فصادف أنها كانت تعرف غليان وإحتجاجات ، لعلها كانت أحدات 1965 ، فأعتقلت و زُجََ بي في “سجن أغبيلة” المشهور، الذي تم إغلاقه بعد إحداث سجن عكاشة ، فرُدِدْتُ لبيان برائتي، لم تتوقف ردوداتي عند هذا الحد ، بل زادت بعدما رُدِدْتُ حين تقدمت للزواج في عدة مناسبات، فاصبحت من مدمني عيطة الراضوني ودأبت على ترديدها في كل مناسبة يرفضونني ويردونني خلالها، ولعشقي لعيطة الراضوني لقبني البعض ب “رْدَيْدَةً” ، لا لذنب إلا أنني كنت عرضة للرد والرفض طوال حياتي .
فكم من رد ورفض في حياتنا وحياة مسؤولينا ،ولكن الغبي فينا من يُرَد ثم يُرَد ولكن يبقى متشبتا بإمتيازاته و كرسيه ، ناكرا أنه رْدَيْدَة، بل معتقدا أنه هو “مقيبيلة”( عليه القبول).
بقلم ابراهيم عروش