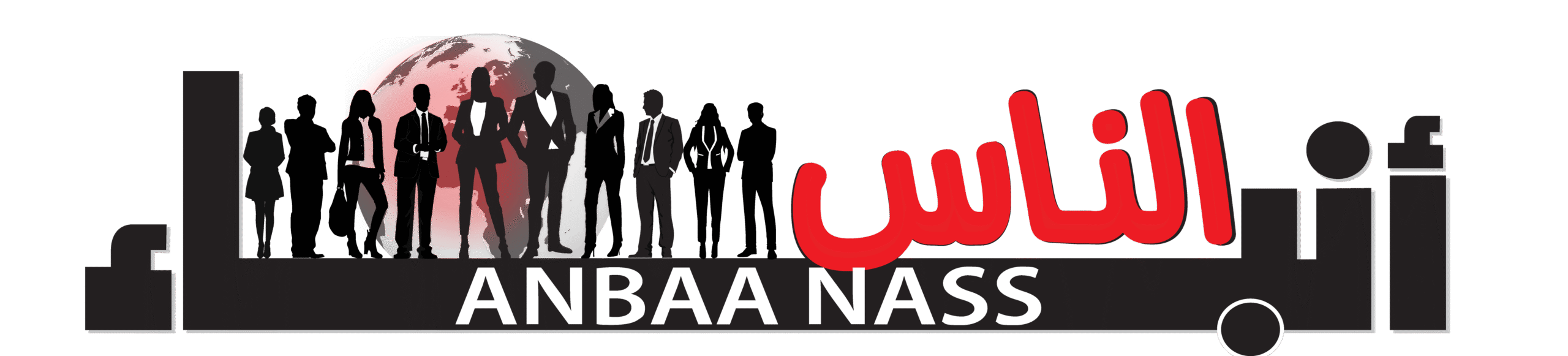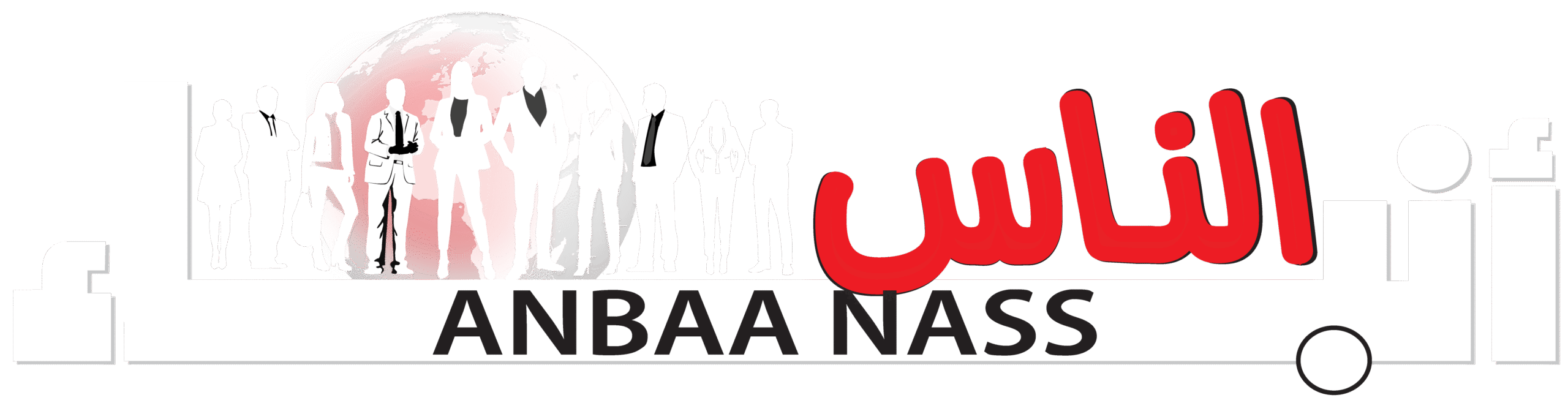بقلم: سيداتي بيدا
لم يكن مساء الثلاثاء 25 نونبر مجرد تاريخ آخر في رزنامة الحوز؛ كانت لحظة انكسار جديدة، سقط فيها رجل من ضحايا زلزال شتنبر داخل خيمة بلاستيكية لم تعد تقوى حتى على حجب الريح، فكيف لها أن تحمي حياة؟ وجدوه جثةً هامدة بدوار العرب بجماعة أسني… جثة لا تحمل فقط آثار البرد والعزلة، بل تحمل في طياتها سؤالًا مُرًّا: إلى أي حد يمكن لمؤسسة أن تطيل عمرَ معاناة مواطنيها دون أن ترتجف؟
نُقل الرجل إلى مستودع الأموات بمراكش، لكن الحقيقة التي نقلها موته بقيت هناك، في الخيمة ذاتها… حقيقة تفضح أكثر مما تُخفي. فوفاته ليست حادثًا فرديًا، بل شهادة قاسية على هشاشة الاستجابة، وعلى أن الزمن وحده لا يكفي لرقع ما تمزق حين يغيب الإنصاف، ويغدو الإنسان مجرد ملحق لائحة أو رقمًا لم يحن دوره بعد.
أهالي الحوز، المنهكون من الانتظار، خرجوا قبل أيام في وقفة احتجاجية يطالبون بأبسط الحقوق: أن يُرى وجعهم. أن يُحسبوا. أن يُعاملوا كمواطنين لا كأطياف تنتظر مرور اللجان. غير أن موت هذا الرجل جاء أقوى من الشعارات، وأبلغ من كل بيانات “الطمأنة”، إذ كشف هشاشة الوعود حين تتأخر، وقسوة الواقع حين ينسحب الدعم إلى مناطق الظل.
إن ما حدث ليس خطأً عابرًا؛ إنه فجوة أخلاقية قبل أن يكون فجوة إدارية. فكيف يستمر متضرر في العيش تحت البلاستيك لأكثر من عام، في بلد يدّعي القدرة على تجاوز المحن؟ وكيف نسمح بأن يتحول العراء إلى قدرٍ دائم، بينما تُدار الملفات المعنية بإصلاح الأضرار ببطء يقتل بصمت؟
الحوز اليوم لا يطلب المستحيل. يطلب فقط أن يُعامل بأدنى درجات الكرامة. أن يتوقف استهلاك خطاب “العناية”، وأن تبدأ مرحلة الفعل لا الوعد. فالمؤسسات التي لا تتحرك إلا بعد الفاجعة، تفقد مبرر وجودها، وتترك الناس يواجهون وحدهم ما لا يُواجه.
لقد رحل الرجل، لكن موته لم يُقفل القصة؛ بل فتحها على مصراعيها. فتحها كمرآة تعكس حقيقة مرة: أن الزمن قد يمحو آثار الزلزال في الأرض، لكنه لا يمحو آثار التقصير في النفوس.
وحتى تُكتب نهاية عادلة لهذه الحكاية، ينبغي أن يُسمع صوت الحوز لا عبر الاحتجاجات ولا عبر النعوش، بل عبر قرارات جريئة، سريعة، وإنسانية… قرارات تعيد للناس حقهم في الأمان، وفي الحياة قبل أن تصبح الموت خبرًا عابرًا.