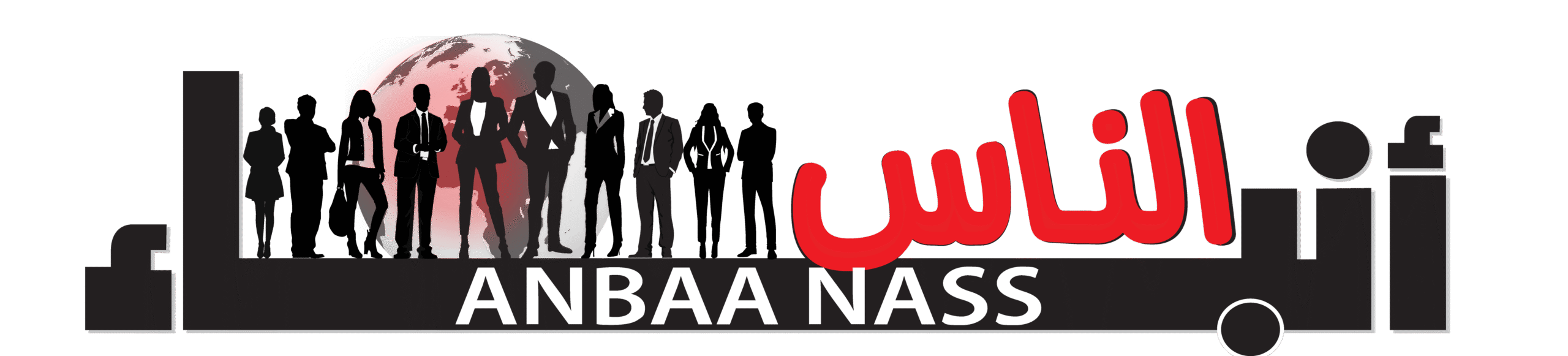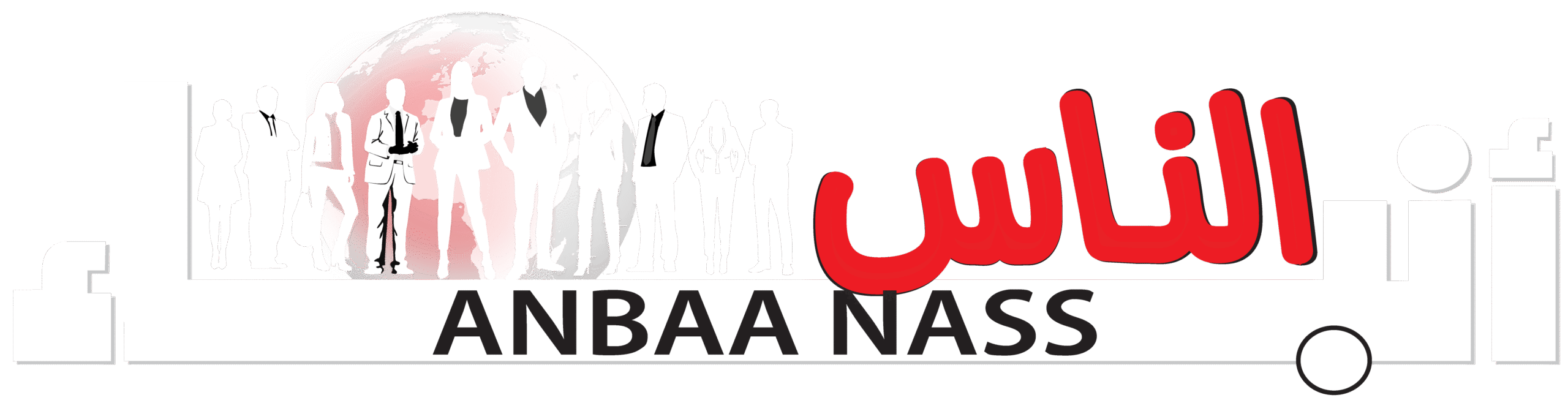بقلم: سيداتي بيدا
تُعدّ مسألة إعفاء بعض نساء ورجال التعليم من مهام التدريس لأسباب صحية من القضايا المهنية التي تكشف، بوضوح، عن اختلالات بنيوية في تدبير الموارد البشرية داخل المنظومة التربوية. فهؤلاء الأساتذة لم يغادروا الفصول الدراسية بمحض إرادتهم، وإنما استجابة لتقارير صادرة عن لجان طبية مختصة أقرت عدم قدرتهم الصحية على الاستمرار في مهام التدريس، حمايةً لسلامتهم الجسدية والنفسية وضمانًا لاستمرارية عطائهم المهني.
غير أن هذا الإجراء، الذي يفترض أن يستند إلى مقاربة إنسانية ووقائية، يصطدم في الممارسة اليومية بواقع مغاير، حيث يُكلف عدد من الأساتذة المعفيين طبيًا بمهام إدارية مرهقة، أو بساعات عمل وضغوط مهنية لا تقل حدة عن تلك المرتبطة بالتدريس، وهو ما يفرغ الإعفاء من مضمونه، ويضعه في تناقض صريح مع الغاية التي أُقر من أجلها.
ويتعقد هذا الوضع أكثر في ظل غياب إطار تنظيمي وطني واضح يحدد بدقة طبيعة المهام الإدارية الملائمة لهذه الفئة، وحدود التكليف، وضوابط مراعاة الوضع الصحي للأستاذ. هذا الفراغ المرجعي يفتح المجال لاجتهادات إدارية متباينة، قد تفضي، في بعض الحالات، إلى ممارسات تمس بالاستقرار المهني والكرامة الإنسانية، وتتعامل مع المرض باعتباره عبئًا إداريًا بدل كونه معطًى يستوجب التفهم والرعاية.
إن تدبير هذا الملف لا ينبغي أن يخضع لمنطق التدبير اليومي الظرفي، بل يستدعي رؤية مؤسساتية شمولية، قوامها الحكامة الجيدة، والإنصاف المهني، واحترام التوصيات الطبية. كما يقتضي الأمر استثمار الخبرة التربوية المتراكمة للأساتذة المعنيين في مهام نوعية ذات قيمة مضافة، تساهم في دعم المنظومة التعليمية دون تعريضهم لمزيد من الإجهاد أو المخاطر الصحية.
وانطلاقًا من هذا المنظور، يصبح فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول الإعفاء الطبي من التدريس ضرورة ملحة، تفضي إلى قرارات تنظيمية واضحة ومنصفة، تُنهي حالة الضبابية، وتكرس مقاربة إنسانية متوازنة بين متطلبات المرفق العمومي وحقوق الأستاذ.
إن صون كرامة رجل وامرأة التعليم، خاصة حين يواجهان إكراهات المرض، ليس ترفًا إداريًا، بل التزامًا أخلاقيًا ومؤسساتيًا. وأي مشروع إصلاحي يتجاهل هذا البعد الإنساني يظل، في جوهره، إصلاحًا ناقصًا، عاجزًا عن ترسيخ العدالة المهنية التي تشكل الأساس الحقيقي لأي منظومة تعليمية ناجحة.